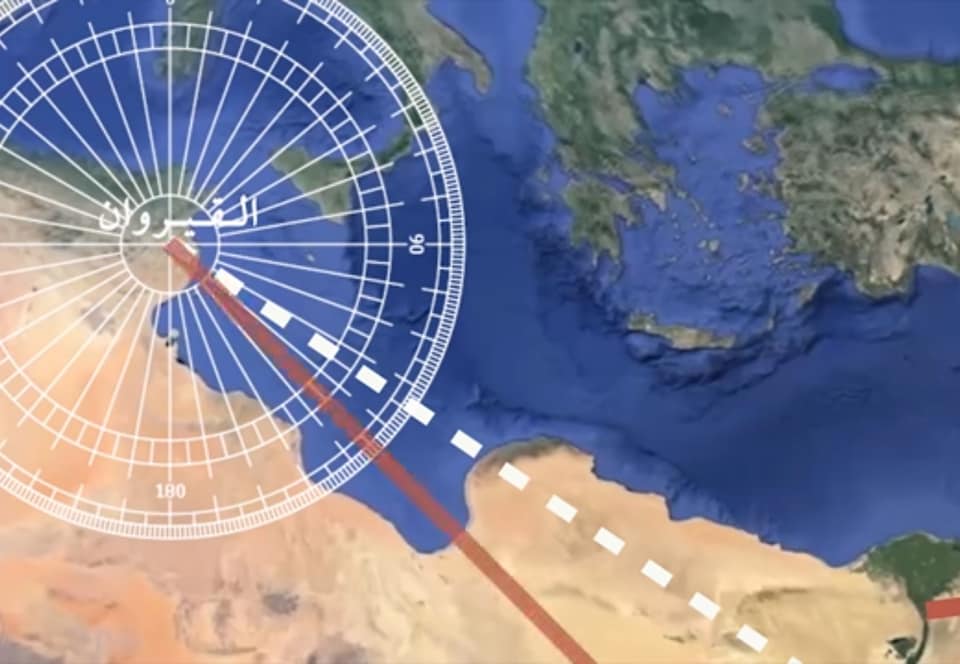لا جدال في مدنية الدولة في الإسلام، وذلك بالرجوع إلى القرآن والسنّة والسّيرة معًا باعتبار أن الرّسول (صلى الله عليه وسلم) لما أراد إقامة حُكمه في المدينة وتاسيسِ دولةِ بيثرب وأسماها المدينة بعد الهجرة إليها؛ فإنّه أخذ البيعة من الاثني عشر نقيبًا من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية رغم أنّهم بايعوه في بيعة العقبة الأولى على بيعة النّساء وأعادوا بيعته في العقبة الثانية على المَنعة أي على ما يمنعون منه نسائهم.
وبلغة أوضح فقد بايعوه على الحَرب، والحرب عمل سياسي بامتياز لتعلقه بشؤون الحكم وقد استوثق له عمه العباس وأوضح لمن بايعوه بالعقبة الثانية علامَ يبايعون ليكونوا على بينة من أمرهم وقد بايعوه على ذلك والحال أنهم مسلمون من الموسم الفارط وأنهم بايعوه على أهم النواهي التي جاء بها القران في باب أحكام المعاملات بما يجعل من بيعة العقبة الثانية ليست بيعة على الإسلام وموضوعُها العقيدة، إنما بيعةً على شؤون الحكم بأن يكون الرسول (صلى الله عليه وسلّم) حاكما على يثرب بأوسها وخزرجها، خاصة وأن حرب يوم بعاث قد اندلعت قبل أكثر من عام، وأن المدينة بقيت بدون سيد يحكمها ويفصل بين الناس فيها للقتال الدائر بين الأوس والخزرج وأن أهل المدينة لم يتفقوا بعد على أمير عليها فكانت بيعة العقبة الثانية التي كانت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا بين طرفين الحاكم والمحكوم وقد تمت البيعة للرسول بما يجعله نائبا عن الجميع في الحكم ويكون هو ولي الأمر عليهم لما يهاجر وهو ما قام به بمجرد وصوله إلى هناك إذ كتب على نفسه كتابا وهو المعروف بالصحيفة والتي حدد فيها الشعب الذي تتكون منه الأمة التي يحكمها والمجال الجغرافي الذي يمارس عليه ذلك الشعب سيادته وأنّ جميع من دخل الصحيفة من المهاجرين من قريش وأهل يثرب ومن لحق بهم وجاهد معهم أمة من دون الناس وأن من تبعهم من يهود فإن لهم الأسوة والنصر غير متناصر عليهم ولا مظلومين.
وأن المدينة جوفها حرام بما يشير بوضوح إلى المساواة بين جميع السكان في الحقوق والواجبات وأن جميعهم أوكلوا الرسول (صلى الله عليه وسلّم) ليحكم بينهم بموجب مبايعته على الصحيفة والحال أن الإسلام منتشر في المدينة بعد أن رافق مصعب بن عمير وفد الأنصار بعد انتهاء موسم الحج والبيعة الأولى بالعقبة بما يدلل أن البيعة للإسلام أمر والبيعة على المنعة و الحرب أمر آخر فإن كانت الأولى هي بيعة على اتباع العقيدة ويرجو من مد يده فيها إلى ثواب ربه والجنة وأنه يبايع الله فيها لقول الله “إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم …” فإن البيعة الثانية بالعقبة كانت بين بشر وبشر وكذلك كانت البيعة على ما كتبه الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) على نفسه بصحيفة المدينة، وفي المحصّلة فإن البيعة على تأمير شخص على مجموعة وقيامه بولاية الأمر عليهم ما هي إلا مجرد وكالة ولو أن بيعة الرسول كانت ذات خصوصية مرتبطة به في صفاته لكونه خاتم النبيين فإن من خلفه من بعده ليست له نفس الصفات وإنه ولئن حكم الناس من بعده أبو بكر ورغم أنه أفضل المسلمين إذ إنه ثاني اثنين إذ هما في الغار فإنه لم يتولَّ الأمر على المسلمين إلا بعد البيعة له بما يفيد توكيله على المسلمين وأنهم أنابوه في شؤون الحكم ملتزمين بطاعته ما أطاع الله فيهم مقابل أن يحكمهم بالعدل.
وإنه ولئن تمت تسميته في البداية بأنه خليفة رسول الله وليس خليفة المسلمين لأنّ لفظة خليفة لغة تفيد النائب فإن الأمر وقع تصويبه في خلافة عمر الذي تمت تسميته بخليفة خليفة رسول الله ثم تمت تسميته بأمير المؤمنين لأنه صاحب ولاية الأمر فيهم بما يؤكد أن البيعة والتي هي اشتقاق من البيع لغة لاشتباه انعقادها بما ينعقد به البيع فإنها مجرد عقد وكالة للحاكم من المحكوم وإن على الحاكم واجب مشاورة المحكومين للأمر الرباني الوارد بالقرآن وإن من أثر الشورى أيضا أن يشارك المحكوم الحاكم في الحكم وأن يكون له صلاحية محاسبته أيضا لأن الحاكم غير معصوم في شؤون الناس والحكم والشواهد على ذلك كثيرة سواء لما قال عمر لما حرم المهور واعترضت عليه امراة بالمسجد فتراجع وهو فوق المنبر بقولته الشهيرة أصابت المراة وأخطأ عمر كما قال أبو بكر في آخر خطبته بعد مبايعته وإلا فقوموني كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وسلّم) برأي سلمان في الخندق وبرأي الحباب بن المنذر بن الجموح في واقعة بدر لما أشار عليه باستدبار آبار بدر وقد سبق ذلك أن سأل الحباب الرسول (صلى الله عليه وسلّم) هل موقع المعسكر هو من وحي أم هو حيلة الحرب فأجابه الرسول أنه من تدبير الحرب فأشار عليه الحباب بعكس ما اختاره الرسول من موقع وأخذ بنصيحة الحباب الذي قال له وعلل قوله بأنه إذا استدبرنا آبار بدر شربنا نحن ولا يشرب عدونا فاستحسن الرسول نصيحته وأخذ بها.
وعلى كل حال إن القول بمدنية الدولة لا يعني أن لا يقع استلهام الشريعة في قوانينها بعتبار أنه إن كانت أغلبية سكان الدولة من المسلمين جاز لهم أن يطبقوا الشريعة التي يعتقدون فيها مع مراعاة وضع الأقليات من غير المسلمين الذين يعايشونهم فيما يطبق عليهم من أحكام قد لا يعتقدون فيها لأنه لا إكراه في الدين وأنه قد تبين الرشد من الغي، ولعله من الجائز القول إن المقصود بالدولة الدينية هي التي يقوم فيها القساوسة أو الأحبار وحدهم بشؤون الحكم وأما في الإسلام فإنه لا رهبانية فيه والدولة مدنية بحتة ويتجه التأكيد على أن العلماء ليسوا رجال دين إنما هم علماء فقط، ولا عصمة لهم وأما الأمراء فهم خدم للأمة ولا حصانة لهم
كما أنه لا مجال للربط بين مدنية الدولة وعدم تطبيق الشريعة باعتبار أن تطبيق الشريعة مسألة راجعة لأغلبية سكان الدولة فإن توفرت الأغلبية فطبيعي أن يطبقوا الشريعة ثم إن الشريعة ليست الحدود فقط وإن الحدود تطبق بمقاصد الشريعة وقد علق عمر بن الخطاب حد السرقة رغم قطعية الحكم المنزل فيها لأن الظرف الزماني لما أصابت الناس سنة جدباء يعارض مع مقصد الشريعة وهو أن يحكم ولي الأمر في الناس بالعدل لذلك فإن البيعة هي عقد متبادل العدل مقابل الطاعة وإن الشورى تحد من طغيان ولي الأمر لأنها تجعل المحكوم مشاركا كما تمكنه من مراقبة الحاكم قصد محاسبته وأما بيعة الملوك فهي معصية لأنها بيعة إكراه وغصب وإن اهمال الشورى من الملك هي طغيان منه والظلم محرم وفي المحصّلة فإن الملك مفسدة مطلقة لأن “الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة”